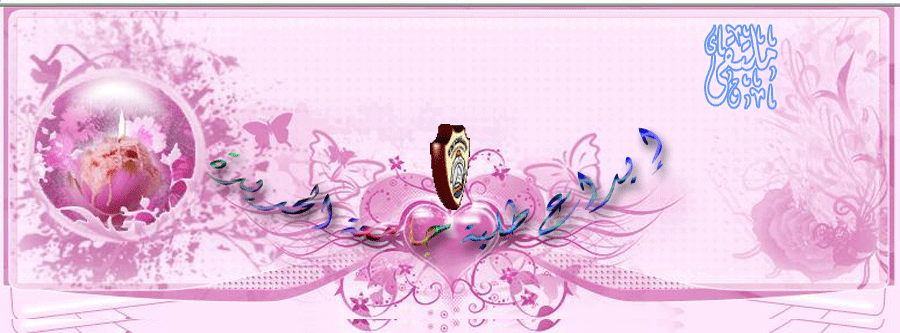للنهضة بصورتها القرائية آمال وأحلام .. دغدغات وأوهام .. حظوظ كبيرة .. وفتوح عظيمة .. أفكار متعالية .. بل وصخب أضغاث .. لكن التجربة التاريخية تؤكد إن سؤال النهضة لايفتأ يندغم في مطالب ومباحث تصحيحية أو تعديلية أو تعميقية للرؤية لعصر السؤال وما قبله .. مثلما تنطلق من شاغل راهن لصلة بأزمة المعنى في الفكر والمجتمع العربي لأن (( غاية النهضة كان طلباً للخروج من العهد القديم – عهد الثقافة المحتكمة الى ذاتها – وطلباً للدخول في العهد (( العصري )) عهد التمدن والإصلاح ، أي عهد الثقافة المتفاعلة مع غيرها )) .
فالتوصيف لمعنى النهضة بكينونتها الأوربية ، هو ما عرفته المدن الإيطالية قبل غيرها في نهايات القرون الوسطى .. إذ تفجر مخاض هذه المدن عن حراك نهضت به التشكيلات الإجتماعية ، مما أدى الى تحقيق إنجازات كبيرة مهدت لتغييرات في اساليب العيش (( ما شكل حقاً ( مثالاً ) للتطور ، بل لإنتاج ( قوة ) حضارية )) تطاولت إمتداداً نحو الخارج بحثاً عن مناطق نفوذ وأسواق .. جالبة معها طرق تفكير جديدة وأنماط عيش فضلاً على تقنيات مستحدثة .. لينتهي هذا التطاول عالمياً الى قمة المأساوية والدموية في (( الإستعمار والإستيطان )) المباشر للقارات الأخرى .. ليحدث هزة مهولة في وعي مجتمعات هذه القارات المستضعفة .
سؤال النهضة الذي شغل تاريخ العرب والمسلمين المعاصر ، ولما يزل هذا التاريخ متورطاً فيه بما يطرحه من رهانات قاتلة .. إنتهى الى أزمة مستغلقة صارت عصية على الحل !! هو سؤال التحديث المجتمعي .. وإنجاز التقدم الحداثي .. والمساهمة في الجهد الإنساني لبناء الحاضر إستشرافاً للمستقبل . أراد هذا التاريخ أن يجري عملية زحزحة ذاتية للتحول من تاريخية السؤال – المأزومة أصلاً – الى تاريخية الإجابة .. لكن أي إجابات ؟ إنها الأزمة بعينها !! لتنتهي الإجابات السجالية والمتناقضة والمشاريعية والشعارية والآيديولوجية الى وهدة الثنائيات الضدية التي أفرزتها الحداثة الغربية لتكتسب حمولة سلبية في الفكر العربي ، تعمق مأزق المشروع النهضوي العربي والإسلامي .. وتجذر ميتافيزيقياه .. وتؤبد إنفعالاته وفنائه في أطنابها من خلال أبعاد تبدو جديدة لكنها تحكي نفس الجسد الثقافي والإجتماعي والسياسي الذي تمسك به روح الإيمان والكفر والتراث والمعاصرة ، والبداوة ةالحضارة ، والنقاوة والعجمة ... الخ
يبدو أن العرب والمسلمين إطلعوا بشكل لا بأس به – خاصة النخب الفاعلة – على المعارف الحداثية وإكتسبوا معارف نظرية ، وإخرى تقنية وعملية كان يمكن أن تمهد لعملية التحديث والتقدم في العالم العربي والإسلامي .. إلا إن غياب الذات الحضارية التاريخية الفاعلة – الملهم التاريخي المضيء – التي بوسعها أن تصوغ إجابات فاعلة وناجعة على تحديات العصر القاتلة ، لعبت الدور الأخطر في هذا الفشل الذي نعانيه حتى الآن .. لكن ليس ثمة من خيار أما الإجابة التاريخية على تحديات النهضة والحداثة أو الموت التاريخي !! (( لذلك فإن مهمة العرب والمسلمين المعاصرة ، تتجلى في توفير كل أسباب وعوامل إنجاز مقولة الذات التاريخية المجتمعية الفاعلة . فهي وحدها التي تخرجنا من عالم السلب والهامشية وتضعنا في قلب الأحداث والعمليات التاريخية الكبرى )) .
لكن كيف يتم خلق هذه الذات وإنعاشها ؟ .. فمؤشرات سيروراتنا الفكرية والإجتماعية والسياسية ليست ذات قابلية تراكمية تصاعدية تواصلية .. بمعنى أن هذه السيرورة حتى في تاريخنا المعاصر بله في الماضي ليست خياراً إنسانياً يستثمر العقل والخبرة البشرية في تحقيق تراكمات وظيفية ناهضة بقدر ما هي سيرورات صنيعة بنى لاهوتية نهائية - لا تاريخية - ، ليست من مهماتها التراكم والإضافة بل التشذيب والتذويب حتى بلوغ نقطة الصفر البدئية ، من خلال إشتغالاتها السجالية غير المنتجة التي لا تكتفي بإقصاء الآخر في حرب الكلمات ، بل لنصول السيوف جولة رهيبة في سجالها القاني . فلبناء الذات التاريخية الفاعلة إشتراطات التغيير لزحزحة المفاهيم الإرتكاسية وإمدادها بالنبض المتشوف الى المستقبل والذي لا يشتغل إلا في الإطار الحضاري التاريخي .. ولبدءها أهمية الإصلاح الديني رغم ما يكتنف مصطلح (( الإصلاح الديني )) من غموض يماهي بينه وبين أفكار المقدس وأنسنة الدين – كأحد أسلحة الأصوليين في محاربة الحداثة – في الوقت الذي يعد فيه الإصلاح الديني شرطاً حضارياً للإنتقال الى النهضة ومن ثم الى الحداثة يبنى على أساس إعادة قراءة الفكر الديني وتراثه وتجديد تفسيره وتأويله (( قراءة منفتحة بعين العصر وبالأدوات المعرفية الجديدة التي تقدمها العلوم .. وفق منطلقات العصر ، يطور إنطلاقاً من الدين ثقافة حافزة على التجديد والتطوير والتحديث كما حصل في أوربا نفسها )) .. إن هذه القراءة العصرية لا تحدث مالم نجنح الى المثاقفة .. أي التعامل مع الآخر حضارياً من خلال تلاقح الثقافات وتأصيل المشتركات الحضارية الإنسانية وذلك لايتم إلا بدمج الخصوصيات وتفعيلها في الثقافة العالمية الإنسانية التي تلتقي وتعطي مثلما تأخذ .. لإعادة تشكيل الوعي العربي وكسر قوالب الأحادية المهيمنة على أجنداته بغيةالقبول بالإختلافات العقائدية والسياسية وتبني الحوار مع الآخر والعمل ضمن إطار الليبرالية السياسية ، والتناغم مع الفهم الحضاري لمفهوماته الإشتغالية والتحرر من الفهم الحدسي والعاطفي واللاهوتي .
إن رفض الآخر كان سمة إلتقاء الغرب بالعرب في العصر الحديث من خلال غزوة نابليون بونابرت عام 1798 م .. لأن طبيعة اللقاء كانت إشكالية .. لما تنطوي عليه من لحظة عنفية قاسية .. أدهشت العرب وأبهرتهم .. لكنها مع ذلك كانت بداية التبرير والتسويغ لما كانوا قائمين عليه من طرق حياة ودولة .. وقد عبر عن ذلك المؤرخ المصري الجبرتي في كتابه (( مظهر التقديس في زوال دولة الفرنسيس )) .. ليكون ذلك ممثلاّ لوجهة نظر مجايليه بشكل عام . بيد ان تطوراً ما حصل في هذه النظرة من خلال الجيل التالي والذي تهيأت له ظروف أخرى مثل حركة التحديث التي قام بها محمد علي في مصر وعلى النمط الغربي .. فضلاً على البعثات التي ذهبت الى الغرب وعرفته عن قرب ورويّة .. مثل رحلة الشيخ الطنطاوي الى فرنسا حيث يقول : (( فالحياة الغربية بخلاف الحياة الإسلامية تطويرية دينامية ، قائمة على مبدأ التغيير والتجديد )) ، لذلك دعا الطهطاوي الى فتح باب (( الإنتقائية الإزائية )) حسب وصف نديم نعيمة ، أي عندما يحصل الإنتقاء من الحداثة الوافدة كما تجسدها المدنية الغربية ، فإن حصل إستحسان لهذا الإنتقاء في ظل التأخر الذي يطبق على المجتمعات الإسلامية .. ما يمكن عندها أن يؤصل في هذا المجتمع شريطة أن يستقيم الإسلام والمجتمع الاسلامي.. وبخلافه فالاسلام بريء من هذا الوافد .. في ظل طروحات نقدية وسطية (( والمقصود بالنقد بهذا المعنى ليس إلغاء المنقود أوتبرير قبوله ، بل بإعتباره موضوعاً للنقد قابلاً في ضوء النقيض أن يسقط منه وأن يضاق إليه )) .
ثم جاء الجيل الثالث ممثلاً بالمفكر الكبير جمال الدين الأفغاني وتلميذه النجيب الشيخ محمد عبده ، ليقدما مساهمة نقدية لإصلاح الفكر الديني الإسلامي من خلال ثورة ثقافية في مجال فهم الدين على أساس مواجهة معضلة العلاقة بين حضارتين على أرض الواقع ، الأولى تتمثل في الحضارة الإسلامية والقائمةعلى الايمان بالغيب ، والثانية تتمثل بالحضارة الغربية الوافدة والتي قوامها الإنسان وعقله ، وقد إجتهد المفكران الكبيران في طرح حلٍ تصالحي وسطي .. أي بناء معادلة فكرية يتصالح فيها العقل والإيمان ، وفق مقولة محمد عبده المعروفة : (( إن الاٌسلام دين العقل والعلم والمدنية )) .. لكن هذا الحل التصالحي لم يؤدِ الى نتيجة كبيرة .. بسبب عجز الفكر العربي الإسلامي عن فهم أو تطوير معادلة العلاقة هذه وكيفية التعامل معها !! .. لأن المعادلة الحقيقية للعلاقة بين الغرب والشرق هي بحسب هذا المفهوم التصالحي والذي مازال نافذاً فينا تقوم على أساس العلاقة بين حركية وتاريخ ونسبية ومدنية هي الغرب .. وبين دين وعقيدة إسلامية ثابتة (( قرآنية مثالية مطلقة )) .. إذن تصحيح هذه المعادلة يتطلب فهماً جديداً يقوم على أساس المواجهة بين تاريخين وحركتين نسبيتين ومدنيتين .. (( حتى إذا إنبثق عن هذه المواجهة الجدلية وهذا التلاقح جديد ثالث فأسقط بموجبه شيء أو آخر من المدينة الإسلامية أو عدل أو اضيف ، كما هو محتم أن يحصل ، لم يكن ذلك تعديلاً في الإسلام كمطلق أو إسقاطاً منه أو إضافة إليه ، وحتى إذا إقتضى الأمر ، كما هو محتم أيضاً أن يقتضي ، قبول شيء أو آخر من المدينة الغربية الحديثة أو رفضه لم يكن ذلك قبولاً بإسم الإسلام أو رفضاً بحجته ))