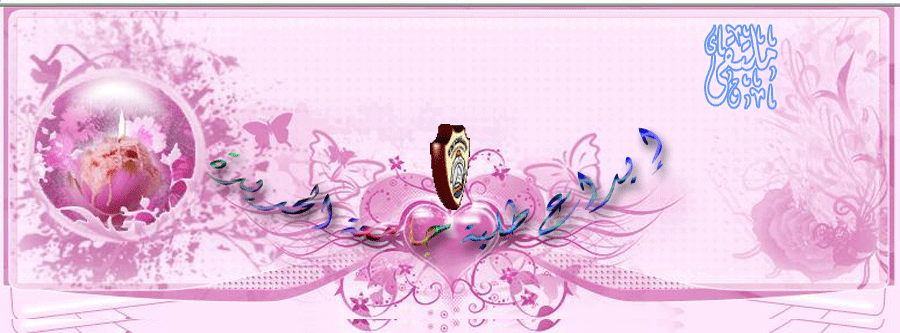فجأة صرت غريباً على الجميع، أقرب الناس إليّ.. أهلي رفاقي أصحابي والجيران، عملي والأشياء، حتى على نفسي في بعض الأحيان. لم يلحظوا التغيير إلا فجأة، لا أعرف لماذا حتى الآن؟.
هل كان تكتّمي بعض الشيء هو السبب، أم هي اللحية التي اعتدت على تربيتها في الجاهلية فلم تثر الشكوك حين طالت قليلاً؟.
لا أعرف حتى الآن ما الذي أطال الكشف عن هويتي الجديدة.. الإسلامية؟! ما عرفته هو أنني انكشفت للجميع فجأة ودفعة واحدة، وكان عليّ أن أرد على الاستفسارات والأسئلة، الكثيرون ممن عرفني لم يصدقني في البداية، وبعضهم لا يزال إلى الآن، حتى أولئك الذين رأوني وأنا أؤذن مرة على مئذنة المسجد ظلوا يعتقدون أنها إحدى فنّاتي التي سأعود طبيعياً من بعدها [فالزلمي متعلم وبيفهم، ولا يمكن أن يصبح إسلامياً، يريد أن يجرّب شيئاً جديداً، سيزهق بعدها ويعود عادياً، هذه طبيعته، نحن نعرفه]. كثيراً ما سمعت مثل هذه العبارات تتردد بين كل من ظن أنه يعرفني، حتى إن إحدى صاحباتي السابقات أكدت عند إعلامها بإسلاميتي.. أن الله لن يغفر لي ذنوبي حتى ولو دقّت ذقني بالأرض جراء ما قمت به في الماضي. من الصعب أن يتقبلك من عرفك بالسابق أن تكون إسلامياً عن جد، وأنت خريج إحدى الجامعات الأميركية، ولا تزال تضع (الجل) على شعرك وتتابع سباقات (الفورمولا ون)، أو تسمع أغاني مرسيل خليفة.
إذا كنت إسلامياً كما يسمونها فيجب أن تكون إما مع هؤلاء، أو محسوباً على هؤلاء أو هؤلاء، ولن يقنعهم إنكارك التبعية لأحد. لا بد وأن هناك شيئاً تخفيه. عزائي الوحيد في كل هذا المحيط الصاخب والمتسائل من حولي عن التغيير الذي هبط علي من المريخ كما يعتقدون، كان إيماني الراسخ بما تعلمته عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال كما أُخبرت عن حديث رواه ابن ماجة والدارمي: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ.. فطوبى للغرباء . قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس.
وكنت سعيداً بأن أكون من هؤلاء الغرباء.
الطريق بين المرتّل في (كورس الميلاد) لمدرسة الفنون الإنجيلية، والمؤذن صاحب الصوت (الشنيع) كما يصفه جيران المسجد.. طويل وغريب، لا سيما أنه يمر بواحدة من أكثر الجامعات اللبنانية تحرراً كما يرونها، وفسقاً كما أراها الآن، لكنني قطعته بسلاسة واقتناع بكل مرحلة منه، لأختار ما أتمنى أن أموت عليه... الإسلام.
منذ المدرسة استهواني وأنا بعدُ ذلك التلميذ الممتلئ بالأسئلة عن الخالق والوجود، والمجتمع والحضارات والروح والجسد وما بعد الموت. ما عرفته عن الفيلسوف الغزالي، طوافاً زاد عن تسع سنوات في المدائن والبلاد ترك خلاله كل شيء بحثاً عن نفسه، وعاد وقد وجدها. سحرتني فكرة ذلك العالم العربي الذي دحض فلاسفة عصره، مع أني لم أعرف عنه الكثير، وبقيت هذه الحادثة حاضرة دوماً في مخيلتي.
أردت أن أقوم بالمثل لكنني لم أستطع، عجزت لضعفي، ولاعتبارات كثيرة أن أترك كل شيء وأبحث عن نفسي و أجوبة عن أسئلتي. فلم أنزو ِ وحيداً في كوخ بعيد لأتأمل كما كنت مخططاً أن أعمل بعد انتهاء دراستي الجامعية. أردت أن أسأل وأستوضح، لكني لم أعرف من أسأل وماذا أسأل!. أردت أن أعرف كل شيء.. بسهولة أو بعناء، لا يهم.. المهم أن أعرف وأن أقتنع بما عرفت. لا أدعي أني تعمقت في الأفكار والعقائد والتيارات التي صادفتها أو سمعت عنها حتى تكوين هويتي الحالية، لكني قرأت عن البعض واطلعت على البعض الآخر خاصة تلك التي كانت متاحة أمام طالب جامعي يبحث عن الانتماء والأجوبة وهو بعدُ صفحة بيضاء.
في السابق لم تستهوني أي من تلك الأفكار بكليتها. أحببت نقاء النفس والزهد في البوذية، والعدالة والمساواة في الاشتراكية، والشعور بالعروبة في القومية، ومبدأ القوة العسكرية في الفاشية، والانسان الخارق في النازية، حتى إنني وضعت صورة لهتلر مرة فوق مكتبي.. ومع كل هذا لم أجد نفسي في أي منها بشكل كلي. دائماً كان هناك شيء ناقص.. وبقيت تائهاً وتنامت عندي فكرة ضرورة التغيير، تغيير كل شيء والثورة على كل شيء. حتى الثالثة والعشرين من عمري لم أكن قد دخلت مسجداً، إلا خلال رحلتين سياحيتين. حتى إن والدي الذي اعتاد صلاة يوم الجمعة فقط.. لم يكلف نفسه يوماً إيقاظ ابنه الأصغر لمرافقته إلى الجامع. لم يكن الدين للأسف أولوية في عائلتي، وهو حال عشرات ألوف العائلات المسلمة في هذه الأمة. فأن تكون متعلماً وصاحب مهنة محترمة.. أهم من أن تخلد إما في النار أو في الجنة.
دخلت الإسلام من أغرب أبوابه.. لم تستقطبني الخطب الرنانة، ولم ألتق يوماً بمن دعاني إلى الدين الحنيف وجادلني بالمعروف. ولم تستهوني المناظرات التلفزيونية أو الكتب الدينية، بل على العكس كانت هيئة المشايخ تثير في نفسي النفور لما راكمته عنهم جراء ثقافة شعبية عامة تأثرت بها دون أن أشعر